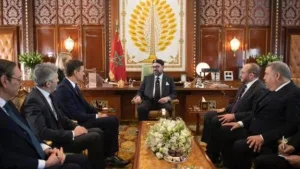ما بين ثنيات الورق وصمت الحجر، تنبني هنا علاقات سلطة لا تقلّ شراسة عن أي معركة سياسية. ليست القضية مجرد تضارب حدود أو مطالبة بقطع أرض، بل محاولة منهجية لتحويل ذاكرة جماعة إلى سندٍ يُباع، وتحويل حقّ مقدّس — حق الحبس على ضريح وليّ — إلى قطعةٍ في سوقٍ عقاري. القراءة العميقة للوثائق المتوفرة تفيد أن هذه الخصومات ليست تقنية فحسب، بل هي عملية إعادة صياغة لشرعية الوجود على الأرض.
الولي الصالح سيدي عيسى امناذ الغرناطي الأندلسي لم يكن مجرد اسم في سجل الأولياء، بل مرجعية روحية جمعت حولها سكان المنطقة منذ قرون. الضريح الذي شُيّد تكريمًا له خُصصت له أرض بعينها، وأُثبت ذلك في الوثائق الرسمية برسم حبوس واضح المعالم. اللافت أن هذه المساحة جرى ذكرها في نصين متطابقين تقريبًا: مرة بعبارة «فيل واحد من جميع نواحيه»، ومرة أخرى بنفس الصيغة مع استبدال كلمة «فيل» بـ «ميل». في كلا الحالتين جرى تحديد حصة كل وارث بدقة، مع ذكر الحدود الطبيعية من الجهات الأربع داخل المساحة الإجمالية للعقار، دون أن يظهر أي مدّعٍ جديد من خارج الورثة الشرعيين أو المحيط المباشر بالضريح.
هذا التكرار في الصياغة، رغم بساطته الظاهرية، تحوّل إلى أداة للتلاعب. فبينما كان المعنى الشعبي للتعبير مرتبطًا بمساحة محدودة ومعقولة تُخصص للولي وأحفاده في إطار الحبس، جرى لاحقًا تحويل كلمة «ميل» إلى مقياس شرعي/هندسي يعطي أبعادًا جغرافية شاسعة، وهو ما فتح الباب أمام المطالبة بمئات الهكتارات، وكأن تغيير كلمة في نص قديم يكفي لتغيير طبيعة الأرض وحدودها.
الحكم القضائي القديم ورسم الحبوس ليسا مجرد ورقتين مهملتين في رفوف التاريخ، بل جهاز شرعي متكامل يصوغ معنى الملكية والحدود. حين نص الحكم على أن الأرض «حبس له»، فقد منحها وضعًا استثنائيًا يتجاوز الملكية الفردية ليمتد عبر الأعراف والذاكرة الجمعية. لكن ما نراه اليوم هو محاولة مقصودة لتفكيك هذا الوضع عبر اللعب باللغة والتأويل، وتحويل النصوص من ضوابط تحفظ الذاكرة إلى أدوات تفككها.
وقد وجدت هذه القراءة سندها في محاولات قيد تحفيظ تفتقر إلى حدود واضحة، ما يوحي باستغلال متعمد لآليات كتابة العقود من طرف بعض العدول وكتّاب الضبط الذين تركوا ثغرات قانونية خطيرة. فالعيب الشكلي في الوثائق يصبح أداةً لتحويل مطالبة تاريخية إلى سند قانوني يُستخدم لنهب الأراضي.
وعند التمعن في مقاربة بعض الباحثين، فإن ما يجري لا يختلف كثيرًا عن تكتيكات استعمارية قديمة. فكما توسعت فرنسا في الجزائر عبر اتفاقيات ظاهرها سلمي وباطنها توسعي، تحاول هذه العصابة اليوم أن تبرر توسعها الاقتصادي والاجتماعي عبر صيغ قانونية ظاهرها شرعي وباطنها استحواذي. الفرق الوحيد أن الفاعل محلي هذه المرة، لكن الأدوات والنتائج تكاد تتطابق: تبرير النهب بأسماء جديدة، وتوظيف مؤسسات الدولة لإضفاء شرعية على الممارسات غير المشروعة.
الوثائق التي بين أيدينا — يقول أحد المتضررين — تقطع الطريق على هذه المحاولات: الحكم القضائي ورسم الحبوس يؤكدان أن الأرض حبس لا ملكية، وأن نطاقها محدد بوضوح للمنفعة لا للتملك. الورثة بدورهم أقرّوا أن الأرض أُهديت للولي، ولم يظهر في محاضر النزاع أي مدّعٍ من أهل الضريح ينازعهم.
هذا الصراع لا يتوقف عند حدّ الأرض، بل يمتد إلى نسيج المجتمع المحلي. إذابة حدود الذاكرة الجماعية وإقحام المؤسسات في لعبة الاستحواذ يهددان بتحويل التاريخ إلى سوق، والذاكرة إلى ملكية خاصة. النتيجة ليست مجرد خسارة جغرافيا، بل فقدان معيار أخلاقي يميز بين الحق المشروع والابتزاز القانوني.
وها هم اليوم، بينما نحاصر الملف بوثائق دامغة، يحاولون تحويل «يل واحد من جميع نواحيه» إلى ما يشبه حوض سباحة ملكي، وكأن الضريح مجرد امتداد لمسطرة عدول. وعلى كل من يستجدي الأوراق ويرقص فوق الحبس، نقول ساخرين كما ورد في أحد التعليقات: بركاتك يا سيدي عيسى، أمولاي قبة خضرة، انقذنا من هذا اليم فأنا لا أعرف فن العوم. فهل سينقذنا الولي من هذه الأمواج القانونية أم سنُترك للغرق في فوضى عدولٍ بلا حدود؟
الحقيقة الثابتة أن كل النصوص، من رسم الحبوس إلى الحكم القضائي، مرورًا بالأعراف الريفية والمذهب المالكي وحتى القوانين الحالية، تؤكد أنه لا يحق لأحد امتلاك أرض الولي الصالح لنفسه. لكن العصابة تسعى إلى سرقتها بنفس الأسلوب الذي استعملته فرنسا للتوسع في الجزائر. إن من يظن أن الذاكرة يمكن أن تُنتزع بقرارات مكتوبة، لم يقرأ بعد صفحات أمجاو، ولن يفهم عمق الإهانة حين تُباع الذكرى بسعر ورقةٍ مُزوَّرة.
18/09/2025